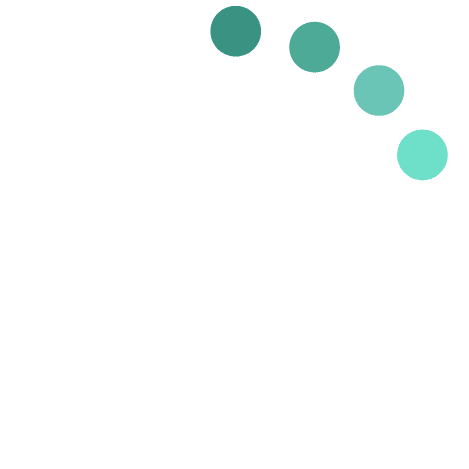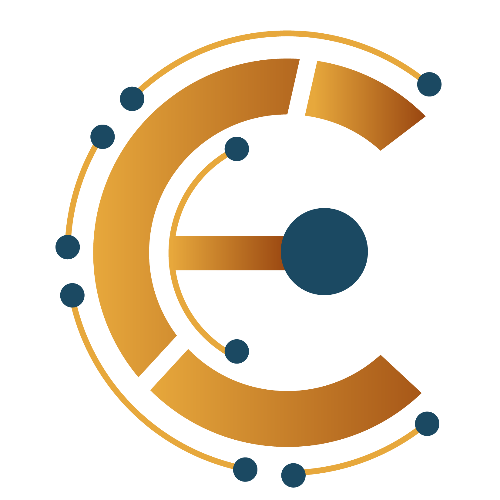الإخوان المسلمين في السودان: رهانات الواقع والمستقبل
متوكل دقاش - باحث
في العام 1924 وبعد إزاحة آخر السلاطين "محمد السادس" ألغيت السلطنة والخلافة الإسلامية معا بقرار رسمي من مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، الذي كان قد ألغى نظام السلطنة في عام 1922 وأعلن قيام الجمهورية التركية وتولى رئاستها عام 1923 وحتى وفاته عام 1938.
وقد كان ذلك عاملا مؤثرا بشكل هائل على العرب الذين قاتلوا على جبهتي القتال، كما وفر ذريعة للقوى الأوروبية لتقاسم غنائم السلطنة التي كانت تعرف بـ"رجل أوروبا المريض" بعد خسارتها الحرب (1) .
بالإضافة إلى ذلك فقد أدى الواقع المنبثق من الحرب العالمية الأولى إلى ولادة سياق جديد في الشرق الأوسط تمثل في تطور ثلاث حركات قومية في الشرق، هي الحركات العربية والتركية والصهيونية التي شكلت تاريخ المنطقة في القرن التالي للحرب. بينما وفي خضم ذلك الوهن والإحباط، ظهرت حركة الإخوان المسلمين كرد فعل على واقع مزري تعيشه الدول والمجتمعات المسلمة التي كانت مستعمرة في مجملها. وبالتالي تبنت الجماعة ومن خلال كتابات مؤسسها حسن البنا عدد من المواقف التي اعتبرت من وقتها أدبيات ومبادئ تعمل الجماعة على تحقيقها. ويأتي على رأس هذه المواقف الموقف من عودة الخلافة، حيث مثلت جماعة الإخوان أحد أهم القوى المعاصرة التي نادت بفكرة الخلافة وضرورة بعثها، وقد امتازت بأنها أقامت تنظيماً دولياً على نمط الخلافة المنشود. وتقول الوثيقة المعنونة "النظام العام للإخوان المسلمين" الإخوان المسلمون في كل مكان جماعة واحدة تؤلف بينها الدعوة ويجمعهم النظام الأساسي. وتهدف الجماعة إلى "إعداد الأمة إعداداً جهادياً لتقف جبهة واحدة تمهيداً لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة (2).
وفي السودان شهد العام 1946 بداية النشاط الفعلي للإخوان من خلال جمال الدين السنهوري، وهو شاب سوداني كان مقربًا من حسن البنا، وعاد إلى السودان خلال تلك الفترة لتأسيس نشاط الجماعة. وفي احتفال أقامه الإخوان المسلمون في مصر عام 1948 بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس الجماعة، ذكر حسن البنا أن عدد شعب الإخوان بلغ ألف شعبة في مصر وخمسين شعبة في السودان، وقد تولى نشاط الإخوان في السودان آنذاك مكتب إداري يرأسه الشيخ عوض عمر إمام؛ قبل أن تعين الجماعة علي طالب الله مراقبًا عامًا لإخوان السودان في عام 1948، لكن سلطات الاحتلال البريطاني رفضت منح الحركة في السودان تصريحًا بالعمل.
في عام 1949، نشأت حركة إسلامية في كلية غوردون التذكارية (جامعة الخرطوم لاحقًا) بهدف مواجهة الشيوعيين الذين كانوا يهيمنون على المجتمع الطلابي. سميت تلك الحركة «حركة التحرير الإسلامي»، وكان على رأسها محمد يوسف محمد وبابكر كرار، تبنت «الاشتراكية الإسلامية»، ورفضت التبعية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. لكن التقارب الفكري والتداخل الكبير بين الحركة وأتباع الإخوان في السودان أدى إلى صراع بين قيادة حركة التحرير وقيادة الإخوان في السودان انتهى إلى عقد مؤتمر لحسم الخلافات.
انعقد المؤتمر بالفعل في أغسطس/آب 1954، وأطلق عليه «مؤتمر العيد»، وانتهى إلى تبني اسم «الإخوان المسلمين»، وانتخاب محمد خير عبدالقادر أمينًا عامًا لها. أغضب القرار مجموعة بابكر كرار التي انفصلت وسمت نفسها «الجماعة الإسلامية» التي أسست فيما بعد «الحزب الاشتراكي الإسلامي». كما أغضب مجموعة علي طالب الله الذي تمسّك بشرعيته كمراقب للإخوان في السودان بتكليف من حسن البنا. وقد تدخل المركز العام في مصر لحسم الخلافات التي تمت تسويتها من خلال انتخاب واحد من أعضاء مجموعة طالب الله كمراقب عام لإخوان السودان، وهو الرشيد الطاهر بكر المحامي (3).
وفي عام 1979، تكرر الجدل الذي لا ينتهي بين إخوان السودان والجماعة الأم في تبعية السودان لها، ورفض الترابي مبايعة التنظيم الدولي للجماعة رغم أنه كان يحلم بتنظيم دولي للإسلاميين من هذا النوع، فبايعه الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد: الذي كان في السجن آنذاك، وانضم إليه الرافضون لرئاسة الترابي منذ 1969، وتولى الحبر يوسف نور الدائم، أستاذ اللغة العربية بجامعة الخرطوم، فرع جماعة الإخوان المسلمين في السودان الذي بقي منذ ذلك الحين جماعة صغيرة الحجم وبلا نصيب من السلطة. اختار الترابي لجناحه منذ ذلك الوقت اسم «الحركة الإسلامية السودانية». لتتحول لاحقا إلى جبهة الميثاق، ومن ثم أخيراً اتخذت مسمى الجبهة الإسلامية والتي دبرت انقلاباً عسكريا مكنها من السلطة في العام 1989.
منذ إمساكهم بدفة السلطة لاحظ الإخوان المسلمين في السودان التباعد بين تصوراتهم الخاصة للحكم والدولة والسلطة وبين ما تمثله هذه المفاهيم على أرض الواقع، وبما تكتنفه من ديناميات داخلية معقدة. ولكنهم تركوا هذا الأمر دون معالجات تذكر وهو أمر لا زال مثير للاستغراب. فمفهوم الحكم الذي يندغم عند الإخوان في مبدأ "الحاكمية" المستمد من فكر ابو الأعلى المودودي سديمي بحيث لا معيار أو أدوات واضحة لتنزيله وتطوير برنامج سياسي على ضوءه بحيث يتضح كيفية ممارسة الحكومة لدورها الوظيفي الكامل.
بينما كانت السلطة وكيفية الوصول إليها هي معضلة الإخوان الثانية. حيث تحول التنظيم الذي كان يتغنى بالديمقراطية إبان وجوده خارج السلطة إلى تنظيم استبدادي بشكل لا يصدق بمجرد وصوله إلى سدة الحكم. وكان ذلك طبيعيا في ظل الانقطاع المفاجئ لتجربة أفراد التنظيم النقابية والسياسية بحادثة الإنقلاب العسكري.
وقد لاحظ غراهام فولر - بحق - أن أحد العيوب الرئيسية في الأنظمة الاستبدادية هو أنها تغلق سبل التجارب السياسية والنضج السياسي أمام الناس. وكان الإخوان المسلمين في السودان بتركيزهم على موضوع السلطة رأسا "دون خطوات تمهيدية" ضحية عدم وجود فرصة للتعلم من المسار السياسي نفسه، بما فيه التفاوض والتنازل، وصناعة القرار، وتطوير قواعد إجرائية في ممارسة السلطة (4)
فقد مثل إنقلاب الثلاثين من يونيو قطعا للسيرورة الطبيعية لنمو حركة الإخوان، ونسف لرصيدهم السياسي المدني، ووأد لتجربة أفراد التنظيم النقابية والسياسية من اجل الوصول إلى السلطة في إطار الديمقراطية.
وذلك بجانب إشكال بنيوي إتسم به فكر الإخوان المسلمين تاريخيا فيما يلي فكرة "الدولة الوطنية " فالتنظيم الذي يحمل بذرة أيديولوجيا"ما فوق دولة " كان دائما ما يخفق في التعامل مع الشروط الصعبة - ولكنها ضرورية - لإدارة مؤسسة الدولة. وكذلك التعامل مع مرتكزاتها وحرماتها بشكل مرن ولا يهدد وجودها وإستمراريتها.
وحرمات الدولة الوطنية ثلاث: الأرض والشعب والمال العام. ولكن بالنسبة للإخوان المسلمين فإن الأرض لله يورثها من يشاء - بينما المال فيئ لهم وبالتالي تكالبت عضوية التنظيم على المال العام ونهبوا منه ما استطاعوا- والأخطر هو تقسيمهم للشعب إلى كفار ومؤمنين، مسلمين وأهل كتاب.
وكان فهم عراب الإخوان المسلمين في السودان للصراع في أفريقيا على أنه: صراع حضاري بين العروبة والإسلام من جهة وبين الشرق والغرب من جهة أخرى، مدخلا لخوض الجماعة لحروب هوياتية في الجنوب وجبال النوبة والانقسنا. بإعتبار سعيهم إلى قلب الموازين من خلال تحويل السودان إلى قطر عربي مسلم خالص بالتخلص من الهويات الأفريقية. دون فهم مغبة الإتجاه نحو هذه المقاربة الأيديولوجية السمجة. التي أفرزت واقعا مريرا مليئ بالحروب والنزاعات التي أدت في النهاية إلى انفصال الجنوب. وهو انفصال لم يستطع الإخوان القابضين على السلطة معالجة تداعياته التي تجلت في تفاقم الأزمة الإقتصادية التي أدت بالإضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى إلى سقوط حكم الإخوان المسلمين في السودان عبر ثورة شعبية بدأت في ديسمبر 2018.
يكتنف واقع الإخوان المسلمين في السودان ضباب كثيف أوله جمود الفكر ووقوف الجماعة عند محاولات عرابها حسن الترابي الفقهية التجديدية ومقارباته السياسية القديمة، وثانيا سيطرة الوجوه القديمة بإستمرار على صناعة القرار وهو واقع تمرد عليه عدد من شباب حزب المؤتمر الشعبي مؤخرا.
وكذلك يحاصر الرأي الشعبي كل ما هو إخواني الآن ويرفض كل ما يثير ذاكرة المجتمع السوداني من سياسات نفذتها الجماعة على مدى سنوات حكمها الاستبدادي. وأيضا يعاني الإخوان سياسيا بكل فصائلهم بما في ذلك المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن - من - الإرث الثقيل للإنقلاب العسكري الذي قامت به الجماعة واستولت من خلاله على السلطة. إضافة إلى نظرة الشك التي تحيط بها واتهامها بمحاولة تقويض الدولة أو إفشالها وجرها نحو الإنزلاق في أتون حروب وفوضى.
الخلاصة...
عطفا على ما سبق؛ يبدو المستقبل قاتم بالنسبة للجماعة. والتي يبدو أنها لم تستفق بعد من صدمة سقوطها المدوي. وذلك بإستماتتها للعودة إلى السلطة عبر إنقلاب عسكري ذو خلفية إسلامية أو عبر إسقاط النظام القائم عبر احتجاجات شعبية.
وحالة الشتات التي تعيشها عضوية الجماعة الآن بالفوضى المؤسسية التي تضرب التنظيم الذي يقبع معظم قادته على مستوى السجون.
وكذلك ثمة إشكالية الهجرة التنظيمية الكاملة فبإختيار المعارضة من المهجر بشكل كبير يتضاءل تأثير الجماعة التي ستبتعد معظم فصائلها عن العمل النقابي والسياسي المباشر.
ولكن كذلك تبدو الفرصة مواتية في حال التجديد والبحث عن مقاربات منهجية وفكرية تغير ديناميكية التنظيم وتجعل خياراته السياسية معقولة. كتلك التي اتجهت النهضة التونسية إليها، بفصلها بين الدعوي والسياسي نسبيا، كفعل ضرورة تمليها الظروف المحيطة والشروط الجديدة. وكذلك الاعتراف بأخطاء الماضي والسعي إلى تلافيها بشكل جاد في المستقبل.
[1] عمران عبدالله، 95 عاما على إلغاء الخلافة العثمانية.. كتابات غربية تروي السقوط، الجزيرة نت، مارس 2019، الرابط https://www.aljazeera.net/amp/news/cultureandart/2019/3/4/إلغاء-الخلافة-العثمانية
[2] محمود إبراهيم، تاريخ الحركة الإسلامية في السودان، مايو 2019، الرابط https://www.ida2at.com/history-islamic-movement-sudan/amp/
[3] الحركة الإسلامية في السودان، حوار مع الدكتور حسن الترابي في المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية الإسلامية، 1987ص19، دار القلم.
[4] محمد مختار الشنقيطي، الحركة الإسلامية في السودان مدخل إلى فكرها الاستراتيجي والتنظيمي، ص22، صناعة الفكر للدراسات، الإنتشار العربي، بيروت، 2011.



 متوكل دقاش
متوكل دقاش